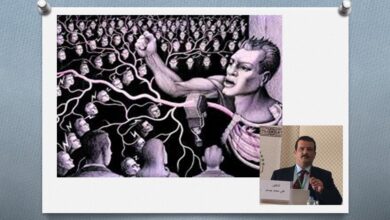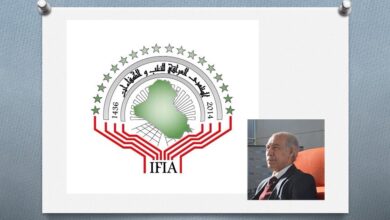الدولة … ونظرية خلق الموارد
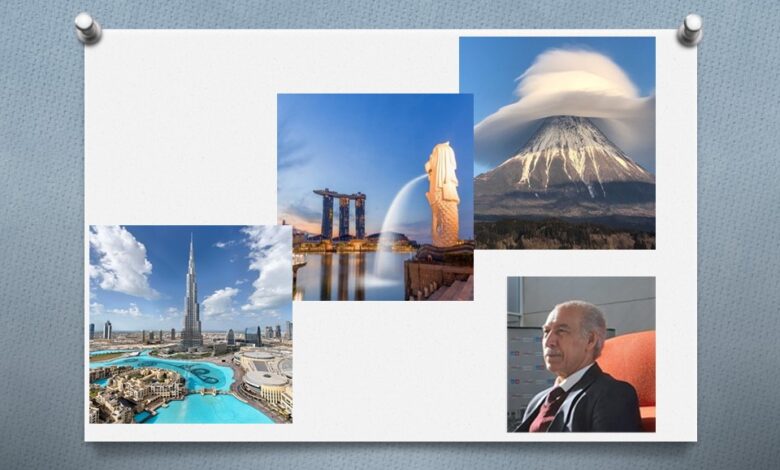
(اليابان، سنغافورة، دبي – نموذجا)
الدكتور حميد شكر الجبوري
نائب الأمين العام للمنتدى العراقي للنخب والكفاءات
المقدمـــــــــــــــة:
علم الاقتصاد هو العلم الاجتماعي الذي يدرس سلوك الإنسان في ظل ندرة الموارد المحدودة لتلبية احتياجات ورغبات متعددة، ويحلل كيف تقوم المجتمعات بإنتاج السلع والخدمات، وتوزيعها، واستهلاكها، لتحديد كيفية استخدام الموارد الشحيحة بأكثر الطرق كفاءة وتحقيق الرفاهية.
وبالتالي فأن علم الاقتصاد ينطلق من مفهوم “الندرة” الذي يعني أن الموارد (مثل الأرض والعمل ورأس المال) محدودة، بينما الرغبات الإنسانية متعددة وغير محدودة.
في حين أرى ان الاقتصاد هو علم وفن إدارة الموارد، حيث انه يبحث في كيف ومتى تخصص الموارد لكل قطاع من القطاعات، في ظل التنازع على الموارد المحدودة، وبغض النظر عما إذا كانت هذه الموارد مما هو متاح محليا” اويتم الحصول عليها من الخارج، او مما كانت تتصف بالوفرة او الندرة، للوصول الى الهدف المنشود الا وهو الحصول على أفضل إنتاجية من هذه الموارد. وهنا يبرز دور الدولة (ممثلة بالحكومة) في كيفية العمل على “خلق الموارد الناقصة”(1) في الدولة وفي كيفية تأمينها، لغرض تكامل عناصر الإنتاج المطلوبة على مستوى الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة.
تاريخيا” وتقليديا”، فان الدول في العصور الأولى للحضارة الإنسانية كانت تسد النقص في الموارد الطبيعية المتوافرة لديها، وذلك من خلال الغزو والاستحواذ على موارد الكيان الذي يتم غزوه. ويشمل ذلك الاستحواذ على الأرض وما فيها من خيرات، واناس وما لديهم من عقول وخبرات، وهو ما عرف لاحقا” باسم “الاستعمار”(2)، واتخذ اشكالا” ومسميات واهداف مختلفة طيلة القرون الماضية.
معنى الدولـــــــــة:
لقد أصبحت كلمة “الدولة” مفردة ملازمة لحياتنا اليومية تحكم وتفسر نشاطاتنا في حاضرنا ومستقبلنا. فما هي الدولة، ماذا نعني بهذه الكلمة وما هي أسسها والغايات التي تسعى اليها.
تميزت العصور القديمة والوسطى بغياب مفهوم الدولة بشكلها الحالي، حيث انتشرت مسميات مختلفة منها (الإمبراطورية، السلطنة، والممالك). إلا أن أغلب الممالك التي حكمت في العصور الوسطى في أوروبا حكمت باسم الدين، فانتشرت الحروب الدينية لمدة ثلاثين عاماً وانتهت في عام (1648) بتوقيع اتفاقية “وستفاليا”، واضعة حداً للحرب الدينية وسلطة الكنيسة على الحكم بإنشاء نظام جديد للدول في أوروبا عرف فيما بعد باسم “الدولة الحديثة” وتَعَمَّمَ في أنحاء العالم فيما بعد.
وثمة تعريف مقبول عموماً للدولة هو التعريف الوارد في اتفاقية “مونتفيديو – Montevideo ” لعام 1933، بشأن حقوق وواجبات الدول، حيث عُرِّفَتْ الدولة بأنها “مساحة من الأرض تمتلك سكان دائمون، إقليم محدد وحكومة قادرة على المحافظة والسيطرة الفعَّالة على أراضيها، وإجراء العلاقات الدولية مع الدول الأخرى”.
مهام الدولة:
لقد نشأ “كيان الدولة” او “نظام الدولة” لتلبية احتياجات المجتمع، وفق ما تعارف عليه لاحقا” باسم “العقد الاجتماعي” بين الشعب الذين يكونون المجتمع، وبين من يترأس ويتولى إدارة نظام هذا المجتمع. ان العقد الاجتماعي هو فكرة فلسفية وسياسية تعني اتفاقًا ضمنيًا أو افتراضيًا بين أفراد المجتمع أو بينهم وبين حكامهم، حيث يتنازل الأفراد عن جزء من حرياتهم الفردية مقابل الحصول على الحماية والعيش في ظل نظام وقوانين تنظم المجتمع وتوفر له الأمن والرفاهية. هذا الاتفاق يحدد الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع والدولة، ويهدف إلى تبرير السلطة السياسية وتحديد حدودها.
ومن هنا نشأ ما يعرف بالمهام التقليدية للدولة، والتي تتمثل بـ (الدفاع الخارجي، الامن الداخلي، القضاء، العلاقات مع الدول الأخرى، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية). الا انه في ظل التطور في القرن العشرين والربع الأول من القرن الواحد والعشرين، حيث حصلت طفرات وثورات علمية في مختلف مناحي الحياة اشبه ما تكون بالخيال، عليه لم تعد المهام التقليدية للدولة مواكبة للعصر، لذلك اضيف الى المهام التقليدية مهام مستحدثة، مثل: دعم الابتكار والتكنولوجيا، توجيه الموارد للقطاعات الإنتاجية، تقديم وتنظيم الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم، رقمنة الإجراءات الإدارية لتحسين الخدمات العامة، وضمان التطور الثقافي والتشريعي.
عناصر الدولة:
ان عناصر الدولة كما وردت في اتفاقية مونتفيديو هي:
- مساحة من الأرض بإقليم محدد.
- سكان دائمون.
- حكومة قادرة على المحافظة والسيطرة الفعَّالة على أراضيها، وإجراء العلاقات الدولية مع الدول الأخرى.
هذه هي العناصر الطبيعية لتكوين الدولة، إذ لا يمكن ان تؤسس دولة بدون ارض، ولا يمكن لهذه الدولة ان تقام بدون سكان، ولا يمكن تأسيس حكومة بدون ارض وسكان، فهذه العناصر متلازمة ومترابطة مع بعضها البعض. ولكن التساؤل هو: ما الحل فيما إذا اختل ركن من هذه الأركان؟
الأرض لا يمكن الاستغناء عنها في كيان الدولة، ولكنها قد تكون ارض جرداء او جبال او صحراء او مستنقعات … وغير ذلك، لا تحتوي على كل او جزء من الموارد الطبيعية، ومثلنا في ذلك (اليابان، سنغافورة، دبي).
ولا يمكن ان يتشكل كيان الدولة من دون ان يكون هنالك سكان على هذه الارض، وهم الذين يستغلون الأرض ويشكلون الحكومة. ولكن أيضا” كحال الأرض الجرداء، يمكن ان يتواجدوا ولكن بعقلية متخلفة وضعيفة فتكون الدولة متخلفة وضعيفة. ويمكن ان يكونوا بعقلية متطورة ومستنيرة فينشؤون دولة متقدمة وعظيمة.
وعليه فأن معادلة النجاح في الدولة تكون: إذا كانت الأرض جرداء او جبال او صحراء، وهي عديمة الموارد او شحيحتها، فيجب ان يكون السكان هم من يعوض نقص موارد الأرض، من خلال الابتكار والابداع وخلق موارد بديلة تسد حاجة الدولة ودول آخرى ليتمكنوا من الحصول على الموارد التي تنقصهم من تلك الدول، وهذا ما فعلته الدول التالية:
أولا” – اليابان:
او كما يحب البعض تسميتها بـ “كوكب اليابان” لتميزها بما ابتكرته وابدعته عقول وايدي سكانها، وهي الدولة التي خرجت مدمرة جراء خسارتها في الحرب العالمية الثانية، وكانت مسرحا” لتجارب الولايات المتحدة الامريكية للقنبلة الذرية في بلدتي هيروشيما وناجا زاكي (06 و 09/08/1945)، ولكنها لم تستسلم لواقع حالها وهزيمتها النفسية قبل المادية في الحرب، فحققت ما يعرف بـ ” المعجزة الاقتصادية اليابانية“، وكما يلي:
- المعطيات الخاصة باليابان:
- أرض اليابان ذات طبيعة جبلية وعرة، حيث تغطي الجبال حوالي ثلاثة أرباع مساحتها، وتغطي الغابات أكثر من (68%) من مساحتها. كما أن اليابان دولة أرخبيلية تتكون من سلسلة طويلة من الجزر، وتقع ضمن “حلقة النار” للمحيط الهادئ، مما يجعلها عرضة للنشاط الزلزالي والبراكين.
- تبلغ مساحة اليابان الإجمالية حوالي (377,915) كيلومتراً مربعاً، مما يجعل ترتيبها الثانية والستين في العالم من حيث المساحة.
- يبلغ عدد سكان اليابان حسب تقديرات عام 2025، حوالي (126,910,755) نسمة.
- لا توجد في اليابان أي موارد طبيعية باستثناء الأسماك.
- كيف نجح النموذج الياباني في تحقيق المعجزة الاقتصادية:
- بسبب طبيعة الأرض، قامت اليابان بتحول اقتصادي ضخم من الزراعة إلى الصناعة، من خلال استيراد المواد الخام وتحويلها لصناعة منتجات تباع محلياً أو يتم تصديرها، مع نهجًا حكوميًا قويًا يدعم الصناعات الرئيسية مثل الصلب والسيارات.
- سخر اليابانيون رؤوس أموالهم للاستثمار في الصناعات التحويلية سريعة النمو، من اجل سد الفجوة التكنولوجية بين اليابان والدول الأجنبية وزيادة قدرتها التنافسية الدولية.
- تحويل العمالة مع التأهيل والتدريب والتطوير من القطاعات منخفضة الإنتاجية مثل الزراعة والغابات، إلى قطاعات إنتاجية عالية مثل الطيران والسيارات والإلكترونيات. إضافة الى عِلم استخدام الإنسان الآلي والذي تتفوق فيه التكنولوجيا اليابانية على باقي دول العالم.
- زيادة التجارة الخارجية، من خلال التخطيط الاستراتيجي والتعاون من قبل الشركات والأفراد والحكومة.
- ومن العوامل المهمة المساعدة الأخرى، هي دعم الولايات المتحدة الامريكية غير المحدود من خمسينيات وحتى تسعينيات القرن الماضي، الى ان بدأت الولايات المتحدة الامريكية بسحب هذا الدعم لاعتبارات متعددة منها اقتصادية وسياسية.
- النتائــــــج:
- نمو اقتصادي هائل: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، مما ساعد اليابان على استعادة قوتها الاقتصادية بسرعة بعد الحرب العالمية الثانية.
- تحول صناعي: انتقلت العمالة من الزراعة إلى قطاعات إنتاجية عالية مثل صناعة السيارات والإلكترونيات، حيث استغلت اليابان التكنولوجيا المستوردة وطورت صناعاتها لتصبح منافساً عالمياً.
- تقدم التكنولوجيا والجودة: تطورت ممارسات الإنتاج مثل مراقبة الجودة الشاملة والإنتاج الخالي من الهدر، مما عزز جودة المنتجات اليابانية وجعلها ذات قدرة تنافسية.
- تطوير البنية التحتية: شهدت اليابان استثمارات ضخمة في البنية التحتية الحديثة، مثل الطرق السريعة والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، مما سهل حركة البضائع والأفراد.
- تحسين مستوى المعيشة: ساهمت هذه التطورات في تحسين الوضع المعيشي للعاملين وزيادة رواتبهم، مما رفع مستوى الرفاهية في المجتمع الياباني.
- ريادة الأعمال والابتكار: ظهرت العديد من الشركات والمبادرات الريادية التي ساهمت في دفع عجلة الاقتصاد وتقديم منتجات وابتكارات جديدة للعالم.
- يبلغ مجموع ارصدة الصناديق السيادية لليابان حاليا”، مبلغ (3,602) مليار دولار امريكي، حيث تحل اليابان في المرتبة الثالثة عالميا” بعد الولايات المتحدة الامريكية والصين.
ثانيا” – سنغافورة:
جمهورية سنغافورة، هي مجرد جزيرة صغيرة تقع في جنوب شرق آسيا، عند الطرف الجنوبي من شبه جزيرة الملايو، يفصلها عن ماليزيا مضيق جوهر كما يفصلها عن جزر رياو الإندونيسية مضيق سنغافورة. وهي لا تمتلك أي موارد طبيعية. ونعرض تجربة سنغافورة، فيما يلي:
- المعطيات الخاصة بسنغافورة:
- طبيعة الأرض: تتكون الجزيرة من أراضٍ منخفضة ومتموجة، تغطيها غابات كثيفة مطيرة ومستنقعات المانغروف، وتتميز بسلسلة صغيرة من التلال، أهمها جبل بوكيت تيماه.
- تبلغ مساحة الجزيرة (734) كم².
- يبلغ عدد سكانها (6) مليون نسمة حسب تقديرات البنك الدولي لسنة (2025).
- نظامها السياسي ديمقراطي رأسمالي.
- العوامل التي أدت الى نهضة سنغافورة:
بدأت نهضة سنغافورة الحقيقية بعد انفصالها عن ماليزيا في 9 أغسطس (آب) 1965. قادها رئيس الوزراء المؤسس “لي كوان يو” من خلال خطة طموحة لتحويل البلاد من دولة فقيرة تواجه البطالة وعدم الاستقرار إلى واحة متقدمة، حيث تم التركيز على ما يلي:
- تُظهر المنهجية السنغافورية تفضيلًا للعقلانية الاقتصادية على الإصلاحات السياسية من خلال تركيزها على بناء دولة قوية اقتصاديًا واستقرارًا اجتماعيًا كشرط أساسي للتطور.
- تطوير نظام تعليمي مُنصِف للجميع، يعتمد على مبدأ ينص على “أن كل طفل أو طفلة يملك أو تملك مواهب بطريقة خاصة”. ووفقا” لهذا المبدأ يتابع الموهوبون دراسياً تعليمهم كما هو متعارف عليه ضمن السُلم الأكاديمي، في حين يرسل الأطفال الموهوبون في مجالات تقنية أو مهنية أخرى إلى المرافق المتخصصة بتعليم وتدريب تلك المهارات.
- تَمثَّلَ أحد الأسباب الرئيسية للنجاح الاستثنائي لسنغافورة، قدرتها على اكتشاف المواهب البشرية والاستفادة منها، بناءً على فرضيتين رئيسيتين أولهما: هو أن بعض الناس أكثر موهبةً من غيرهم بحكم الطبيعة. وثانيها: أن المواهب والقدرات الاستثنائية يمكن أن نجدها بين الفقراء كما نجدها بين الأغنياء دون فرق.
- النظام القائم على “الجدارة”، فمن خلال نظام خدمة مدنية عامة متقدم، تكون السياسات الخاصة بالترقية فيه وفق الجدارة وليس الاقدمية، ويمنح رواتب تنافسية مماثلة للتي تُمنح في القطاع الخاص.
- القضاء على الفساد، من خلال منح عقود التوريد في القطاع الحكومي على أساس اوطأ الأسعار مع مراعاة الجدارة، بما يضيف قيمة أفضل للشعب والمجتمع.
- من العوامل المهمة الأخرى في نجاح سنغافورة في نهضتها الأولى هي دعم بريطانيا، التي استعمرتها ونظمت اقتصادها كميناء تجاري استراتيجي. لكن الولايات المتحدة الأمريكية لعبت لاحقًا دورًا هامًا في توفير الاستقرار والحماية لدولة سنغافورة الناشئة، مما سهل تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها.
- النتائج:
- يتربع قطاع الخدمة المدنية السنغافوري على قائمة أفضل نُظُم الخدمة المدنية في العالم. وبفضل تطبيق منهج الجدارة عالي الأداء في قطاع الخدمة المدنية، تفوقت سنغافورة على معظم الأمم والدول الأخرى في كل مؤشر من مؤشرات التنمية البشرية تقريباً.
- تعد سنغافورة الان مركزًا صناعيًا رئيسيًا، تنتج: الكيميائيات…وغيرها. كما تعد أيضًا مركزًا رئيسيًا للصناعات الغذائية، وتكرير النفط، وبناء وإصلاح السفن.
- على الرغم من صغر حجمها، تعد سنغافورة الآن الشريك التجاري الخامس عشر للولايات المتحدة، ولديها اتفاقيات كبيرة مع العديد من البلدان في أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا أيضًا.
- بمساحة (734) كيلو متر مربع، وقوة عاملة صغيرة من (3) ملايين شخص، فإن سنغافورة قادرة على إنتاج ناتج محلي إجمالي يتجاوز (547) مليار دولار سنوياً – 2024، أي تتصدر أكثر من ثلاثة أرباع دول العالم.
- متوسط العمر في سنغافورة (83.75) سنة، وهو ثالث أعلى معدل في العالم. تعتبر سنغافورة واحدة من أفضل الأماكن للعيش على وجه الأرض.
- على النقيض من الدول الأخرى التي تتربع فوق بحار هائلة من الثروات الطبيعية، تمكنت سنغافورة من إنشاء صناديق للثروة السيادية يبلغ مجموعها (2,095) مليار دولار امريكي – 2025، حيث يأتي ترتيب سنغافورة السادس عالميا”. في حين تُهدر الدول الأخرى التي تجني مليارات الدولارات من الصادرات النفطية هذه الثروات، حيث يتسرب بعضها لجيوب الفاسدين.
ثالثا” – أمارة دبي:
بالعودة إلى عام (1833)، بدأت دبي كمستوطنة صغيرة من قبل حوالي (800) فرد من قبيلة بني ياس، الذين انجذبوا إلى الميناء الطبيعي الذي أنشأه الخور الذي يتدفق عبر دبي. حولوا المنطقة إلى مركز صغير لصيد الأسماك واللؤلؤ. ونعرض فيما يلي تجربة دبي في التطور والازدهار:
- المعطيات الخاصة بدبي:
- طبيعة أرض دبي صحراوية قاحلة تتكون بشكل أساسي من الكثبان الرملية الواسعة، التي هي امتداد لصحراء الربع الخالي. كما انها تمتد على ساحل الخليج العربي.
- تبلغ مساحة دبي (4114) كيلومترًا مربعًا.
- يبلغ عدد سكان إمارة دبي حوالي (3.9) مليون نسمة حسب تقديرات 2025، حيث يشكل المواطنون نسبة (10%) من السكان.
- العوامل التي أدت الى نهضة دبي:
- عرفت دبي كيف تستثمر عوائد تصدير النفط في تطوير البنية التحتية للقطاعات الأخرى، مثل الموانئ والمناطق الحرة والطيران والشركات القابضة، والفنادق والإسكان والمدارس والمستشفيات.
- وفرت المناطق الحرة حوافز استثمارية كبيرة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، مما شجع الشركات المحلية والدولية على تأسيس أعمالها وتوسيع نطاقها في دبي.
- تم تنويع الاقتصاد في قطاعات مختلفة، بحيث أصبحت موارد النفط ثانوية قياسا” بموارد الأنشطة المستحدثة.
- رغم ان معظم أراضي دبي صحراوية قاحلة وجبال وسهول حصوية، الا انها عرفت كيف تستغل شواطئها البحرية في بناء الموانئ المختلفة، والمنتجعات السياحية.
- عرفت دبي كيف تتحول الى منطقة جذب سياحي من خلال أنشطة فريدة مثل: برج العرب، نخلة جميرا، برج خليفة، مراكز التسوق الضخمة، نافورة دبي مول، المنتجعات الفندقية الساحلية والصحراوية، وميدان سباق الخيل الدولي … وغيرها من الأنشطة.
- جذبت دبي الاستثمارات الخارجية، وأصبحت مركزا” إقليميا” ودوليا” في مجال المصارف والتأمين والنفط وشركات المال والتحكيم، والذهب والماس والمعادن الثمينة … وغير ذلك.
- تسعى دبي لتحقيق مراكز ريادية في عدة قطاعات رئيسية تشمل: الخدمات اللوجستية، الخدمات المالية (بهدف أن تصبح من أفضل 4 مراكز عالمية)، التصنيع، السياحة (لأن تكون من أفضل 3 وجهات عالمية). بالإضافة إلى أهدافها في أن تكون مركزاً عالمياً للتقنية والابتكار في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية، الرعاية الصحية، الفضاء، التجارة الإلكترونية، والمدن الذكية.
- النتائـــــج:
- أصبح ميناء الخليج المظلم، مركزًا رائدًا في العالم للتمويل والإعلام وصناعة السفر والطيران والعمليات والابتكار والتطوير والشحن، ويتمتع بتكلفة تنافسية وبمستوى معيشة مرتفع. ويعمل في خدمة هذا الاقتصاد أكثر من (120) خطاً ملاحياً ترتبط عبر (85) شركة طيران بأكثر من (130) وجهة عالمية.
- الطفرة العمرانية الهائلة، على الصعيد الوطني، حيث تشير التقديرات إلى أن هناك ما يقرب من (350) مليار دولار من مشاريع البناء النشطة.
- حلت دبي في المرتبة الرابعة عالمياً في تقرير «المدن الأكثر زيارة 2024»، حيث اجتذبت إمارة دبي (15.8) مليون زائر، كما أن قيمة إنفاق الزوار بلغت (30) مليار دولار.
- لم يعد اقتصاد دبي اليوم معتمداً على النفط، فهو متنوع ويرتكز بشكل أساسي على قطاعات: التجارة، الخدمات، التمويل، تستفيد دبي من (6%) فقط من ناتجها المحلي الإجمالي من النفط.
- أصبحت دبي تجسيدًا للثروة والرفاهية والازدهار والتنمية الاقتصادية. ومن خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وكونها موطنًا لقطاع العقارات والتكنولوجيا والمالية والرعاية الصحية والسياحة المزدهرة، تقترب دبي من أن تصبح المركز العالمي الأول للثروة.
- يُتوقع أن يصل عدد المليونيرات في دبي إلى أكثر من (81) ألف شخص بحلول نهاية عام 2025. وتُعزز دبي سمعتها كمركز عالمي للثروة نظرًا لبيئتها الضريبية المواتية، والبنية التحتية المتقدمة، وسياسات الإقامة المرنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- كلمة “خَلْق” في اللغة العربية لها معانٍ متعددة حسب السياق، وتشمل الإيجاد من العدم (وهو صفة خاصة بالله تعالى)، وإيجاد الشيء من مادة موجودة (مثل خلق الأثر الفني). مرادف كلمة خلق: أَبْدَعَ، أَبْرَأَ، أَحْدَثَ، أَنْشَأَ، أَوْجَدَ، إِبْتَدَعَ، إِبْتَكَرَ، إِخْتَرَعَ، إِخْتَلَقَ، إِسْتَحْدَثَ، إِسْتَنْبَطَ، إِكْتَشَفَ، اختَرَعَ، بَدَعَ، بَرَأَ، تَسَبَّبَ بِـ، جَبَلَ، خَلَقَ، ذَرَأَ، سَبَبَ، سَوَّى، شَكَّلَ، صاغَ، صَنَعَ، صَوَّرَ، طَبَعَ، فَطَرَ، كَوَّنَ، وَلَّدَ.
والمقصود بالخلق هنا الايجاد والابتكار والاختراع والاستحداث، ولكن بأساليب وأدوات غير تقليدية.
- الاستعمار في اللغة العربية يعني إعمار الأرض واستصلاحها لتصبح مؤهلة لعيش البشر ويكون ذلك عن طريق استغلال ثرواتها بما فيه خير البشرية وذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: {هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأرض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}. اما اصطلاحا” فهو سيطرة دولة قوية على دولة ضعيفة، واحتلال أراضيها واستغلالها عسكريًا واقتصاديًا وثقافيًا، وغالبًا ما يتم ذلك بالقوة ويهدف إلى تحقيق مصالح الدولة المستعمرة.
- سيتم نشر البحث كاملا” في العدد المقبل / تشرين الأول 2025، من مجلة اوروك التي تصدر عن المنتدى العراقي للنخب والكفاءات – إسطنبول.