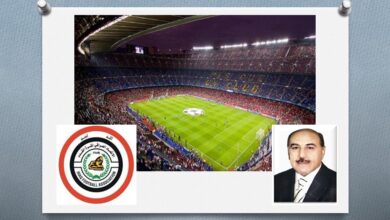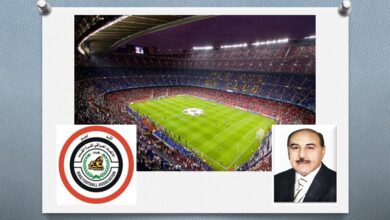الأثار السلبية للبطالة والأمية والإنحراف على مستقبل الشباب وسبل مواجهتها

أ . د إسماعيل خليل إبراهيم
نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة
الشباب والبطالة : البطالة في اللغة : التعطل والتفرغ من العمل . وتُعَرِف منظمة العمل الدولية العاطل عن العمل بانه ( ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة بلا عمل وهو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه عند مستوى اجر سائد لكنه لايجده ) ، وهذا يعني ان البطالة تعطيل لطاقات تبحث عن العمل وبإمكانها أداء متطلباته لكنها لاتجده .
والبطالة ظاهرة لايتوقف تأثيرها السلبي على الحالة الإقتصادية فقط بل تشمل الجوانب النفسية والإجتماعية والسياسية والأمنية ، وتكمن خطورتها في انها تستهدف جيل الشباب الذي هو جيل العمل والإنتاج والإبداع والبناء . وإذا ما نظرنا إلى شباب العراق سنجد ان نسبة العاطلين منهم عن العمل ومن بينهم حملة الشهادات تشكل خطرا على مستقبل العراق ومسيرة البناء والتنمية فيه .
اسباب البطالة :
1- الهجرة من الريف إلى المدينة أملا في عمل اكثر يسرا .
2- تلكؤ خطط التنمية وقلة حجم الإستثمار .
3- تدني مستوى التعليم .
4- ضعف الترابط بين التعليم واحتياجات سوق العمل لقلة الدراسات حول هذا الموضوع مما ادى إلى التوسع في عدد من الإختصاصات دون معرفة حاجة السوق الحقيقية لها ، والإفتقار إلى اختصاصات اخرى يحتاجها سوق العمل .
5- النظرة الدونية لبعض انواع الأعمال مما ادى إلى الإنصراف عن امتهانها .
6- اعتماد هيكلية الإقتصاد العراقي على القطاع العام بشكل رئيس وإضمحلال دور القطاعين المختلط والخاص مما جعل الوظيفة الحكومية الملاذ الوحيد لطلب العمل .
7- التمييز الجنسي والعرقي والطائفي .
8- زيادة نسبة النمو السكاني مقارنة بنسبة النمو الإقتصادي .
9- توقف العديد من المصانع والمعامل والشركات الحكومية عن العمل مما أدى إلى الاستغناء عن العاملين فيها .
10- العمالة الوافدة من خارج العراق .
الأثار السلبية للبطالة :
1- خسارة جزء مهم من الثروة الوطنية البشرية يتمثل بالشباب انفسهم ، وخسارة المردود الإقتصادي الذي بإمكانهم اضافته إلى الناتج الوطني .
2- هدر في الأموال التي تصرفها الخكومة على تعليم الشباب والتي يفترض ان تسترد عن طريق ناتج العمل الذي يمارسونه مستقبلا في شتى الميادين .
3- ضعف الإنتماء الوطني لشعور الشباب بتخلي الحكومة عنهم وتركهم على قارعة الطريق .
4- تضعف البطالة الطموح في نفوس الشباب وتفقدهم الثقة بانفسهم وبإمكانية بناء مستقبلهم العائلي والمهني والإقتصادي الذي يشكل العمل ركيزته الأساس .
5- تعثر عملية التنمية التي يقوم جزء منها على اكتاف الشباب .
6- تؤثر البطالة سلبا على الجوانب النفسية والصحية والجسدية والعقلية للشباب ، اذ انها تقود إلى الكسل والخمول اللذان يقودان إلى اعتلال الصحة ووهن الجسد وبلادة العقل والإحساس بفقدان قيمة الذات ، وشعور العاطل انه عالة على الأخرين .
7- زيادة ظاهرة العنف المجتمعي ، وإمكانية استغلال العاطلين من قبل جماعات معادية للبلد .
8- الهجرة إلى خارج الوطن بحثا عن العمل مما يفقد الوطن طاقات هو أحوج ما يكون اليها ، ويعطي الفرصة للأخرين لإستثمارها والإستفادة منها .
9- الإتجاه نحو شرب الخمور وتعاطي المخدرات وزيادة نسبة الجريمة والإنتحار .
10- الإحجام عن المشاركة في الحياة السياسية والإجتماعية .
11- العداء للمجتمع وعدم الإلتزام بالقوانين والقيم والأعراف والتقاليد .
12- تفشي حالات القلق والكآبة واليأس بين صفوف العاطلين وهي حالات يمتد تأثيرها وإنعكاساتها السلبية إلى العائلة وتؤدي إلى زيادة المشاكل بين أفرادها وتهز إستقرارها وترابطها .
13- اضطرار الفرد أو العائلة إلى العيش بالحدود الدنيا وتحمل معاناة الفقر والفاقة وهي حالة تؤثر سلبا على الحالة النفسية للفرد أو العائلة وعلى مسيرة الإعداد المستقبلي لأفراد الأسرة ولاسيما الصغار منهم .
14- بروز المشاكل الإجتماعية والأخلاقية ومن بينها تأخر سن الزواج أو العزوف عنه .
15- اتساع فجوة الفوارق بين طبقات المجتمع مما يهدد الأمن المجتمعي ويشكل خطورة بالغة عليه .
سبل معالجة البطالة :
1- قيام الحكومة بإجراء مسوحات لإحصاء أعداد الشباب ونسبتهم في المجتمع ، ومعرفة نسبة العاملين والعاطلين منهم .
2- أن تنهض الحكومة بواجباتها وتتحمل مسؤولياتها في مكافحة البطالة عن طريق إعادة الحياة إلى القطاعين المختلط والخاص ، وتقديم الدعم المالي للمشاريع الصغيرة كي لايبقى القطاع العام المنفذ الوحيد لطلب العمل .
3- إلزام المستثمرين اي كانت صفتهم وجنسياتهم اعتماد العمالة العراقية بدلا من العمالة الأجنبية وفي شتى ميادين العمل .
4- إعادة تشغيل المصانع والمعامل التي توقفت عن العمل منذ الإحتلال إذ ان ذلك سيسهم في استقطاب أعداد لايستهان بها من العاطلين .
5- ربط العملية التعليمية بسوق العمل وإيقاف التوسع الكيفي في فتح الجامعات والكليات الأهلية و الأقسام العلمية في الكليات والمعاهد الحكومية .
6- قيام وزارة التخطيط بإجراء مسوحات ميدانية لمعرفة حاجة سوق العمل من الإختصاصات لمختلف المراحل الدراسية ، وتحديد الحاجة المستقبلية على ضوء خطط التنمية ومجالات الإستثمار والتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي .
7- قيام وزارة العمل والشؤون الإجتماعية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط بافتتاح مراكز تدريبية لتأهيل العاطلين عن العمل من مخرجات التعليم الأولي للمهن التي يحتاجها المجتمع .
8- تفعيل دور البطاقة المدرسية – التي يتم التعامل معها حاليا بلا مبالاة – لكونها توضح مسار توجهات التلميذ والطالب العلمية والمهنية مما يساعد على توجيهه الوجهة الملائمة لإمكاناته ومواهبه ورغباته وقدراته وهو ما يساعد في استثمار الطاقات في مكانها المناسب بدلا من إعادة تشكيلها على وفق معطيات قد لاتكون ملائمة او صحيحة .
9- إعادة تأهيل الفائضين عن حاجة بعض مواقع العمل لمهام جديدة تؤمن الإستفادة من إمكاناتهم وطاقاتهم بدلا من تفاقم أثار البطالة المقنعة التي تعاني منها العديد من مواقع العمل .
10- توعية المجتمع بأهمية احترام المهن اي كانت طبيعتها لأنها تصب في النهاية في خدمة المجتمع ولاتنتقص من قيمة الإنسان مادامت مصادرها شريفة .
11- القيام بحملات تثقيفية في وسائل الإعلام والمدارس لخلق وعي مجتمعي بان التوجه نحو التدريب المهني والعمل الحرفي لاينتقص من قيمة الإنسان وان أعدادا كبيرة في شتى دول العالم تتجه هذا الإتجاه ، وان الشهادة ليست السبيل الوحيد لإثبات الجدارة وتحقيق الذات وخدمة الوطن والمجتمع .
12- إيجاد الحلول الناجحة لمكافحة بطالة حملة الشهادات العليا ، وأن تكون هنالك خطط واقعية لتحديد الإختصاصات التي يحتاجها البلد على مستوى الدراسات العليا والأعداد التي يفترض قبولها في كل اختصاص سنويا .
13- الإستعانة بطلبة الدراسات العليا – الماجستير والدكتوراه – لدراسة مشكلات الشباب واقتراح الحلول لها .
14- قيام وزارات التخطيط والشباب والرياضة والعمل والشؤون الإجتماعية بدراسة مشكلات الشباب ميدانيا وليس من وراء المكاتب والإستعانة بأساتذة الجامعات والمنظمات والهيئات التي تعنى بالشباب لإنجاز هذه المهمة .
الشباب والأمية : الأمية في اللغة : من لايعرف الكتابة ولا القراءة ، وتُعَرِفُها الأمم المتحدة بأنها ( عدم القدرة على قراءة وكتابة جمل بسيطة في أي لغة ) ، والأمية افة تنخر في جسد المجتمعات التي ادركت خطرها فسعت إلى التصدي لها ومكافحتها ومنها من نجح وكان نجاحه من اسباب تقدمه وتطوره ، ومنها من تعثر ، ومنها من فشل وظل في خانة الدول المتخلفة . ومما يحز في نفس كل عراقي ان نعود في بداية الألفية الثالثة للحديث عن الأمية في بلدنا وسبل مكافحتها بعد ان تحولت إلى ظاهرة خطيرة ولاسيما في أوساط الشباب الذي يشكل بموجب بعض التقارير نسبة ( 62 % ) من المجتمع مما يهدد مستقبل البلد الذي سيتولى هؤلاء الشباب الأميون مسؤوليته مستقبلا .
إن تحديد الأمية بعدم معرفة الكتابة والقراءة لايعني أبدا أنهما الوجه الوحيد لها إذ هنالك أنواع عديدة لها وإن كان الجهل بالكتابة والقراءة أحد ابرز اسبابها .
اسباب الأمية :
1- الفقر : يعد الفقر من بين اقسى وأصعب ما يمكن ان يواجهه الإنسان في حياته ، ولقسوته فإنه يصرف تفكيره عن كل شيء باستثناء التفكير في الحصول على المادة لتأمين مستلزمات الحياة الأساسية من مأكل ومسكن وملبس ، ومن بين ما ينصرف عنه الإنسان التعليم وذلك لإستثمار وقته في العمل أو في البحث عنه ، لذلك فإن المناطق الفقيرة تضم غالبا النسبة الأكبر من الأميين لاسيما وان عوائل كثيرة تدفع بأبنائها في مختلف مراحلهم العمرية بإتجاه العمل في محاولة لتأمين المتطلبات الأساسية للحياة . لذلك فإن القضاء على الفقر خطوة مهمة بإتجاه القضاء على الأمية .
2- غياب الرقابة : تعد الأسرة واجهزة الدولة المعنية بالتعليم اهم الجهات التي يقع عليها واجب مراقبة انتظام والتزام الشباب بالتعليم ، إذ يُعَد التسرب من الدراسة من العوامل المساعدة على تفشي الأمية ، فالأسرة قد تفاجأ برسوب ابنائها وربما فصلهم من الدراسة بسبب الغياب أو الرسوب في الإمتحانات لأكثر من سنة دون أن تعلم الأسرة شيئا عن حال ابنائها في دراستهم بسبب عدم متابعتها لهم ، وربما تحجم بعض العوائل عن إرسال ابنائها إلى المدرسة في ظل غياب رقابة الدولة ومتابعتها ولاسيما في مسألة تطبيق قانون التعليم الإلزامي .
وتتحمل الهيئات الإدارية والتعليمية في مختلف مراحل التعليم مسؤولية عدم متابعة التلاميذ والطلبة المتأخرين دراسيا اوالذين تتكرر غياباتهم إلى الحد الذي يستوجب فيه فصلهم من الدراسة ، إلى جانب ضعف دور مجالس الأباء والمعلمين التي باتت شكلية إلى حد بعيد . وليس من شك في ان غياب أو ضعف الرقابة والمتابعة يوفران أجواءا ملائمة للشباب للإنصراف عن التعليم .
3- سوء حال الأبنية المدرسية :
يؤثر المكان سلبا أو ايجابا على شاغليه بحسب نوعيته وجودته وملائمته لما أُعِد لإستخدامه ، وفي الوقت الذي تعتني فيه دول العالم أشد العناية بأبنيتها المدرسية وتزودها بكل ما يحتاجه التلاميذ والطلبة ليزدادوا محبة لها وتعلقا بها ، في ذات الوقت تعاني الكثير من مدارسنا من الإهمال وتفتقر إلى ابسط ما يفترض توفيره للتلاميذ والطلبة لذلك لايكون مستغربا نفور أعداد منهم من مدارسهم ومن المؤكد ان تضاف هذه الأعداد إلى أعداد الأميين .
4- ضعف كفاءة الإدارة المدرسية وأعضاء الهيئات التعليمية :
إن تكليف غير المؤهلين بمهام الإدارة ساهم بشكل مباشر في إضعاف دورها في ميادين المتابعة والرقابة والتقويم ، وساهم في فقدان ثقة أولياء الأمور والتلاميذ والطلبة بها ، ومتى ما كانت الإدارة دون المستوى المطلوب انخفظ مستوى أداء العاملين بمعيتها وهو ما يؤثر بشكل سلبي على تلاميذ المدارس وطلبتها ويتساوى حينها حضورهم للمدرسة من عدمه .
وبما أن الثقل الأكبر من مهمة التعليم يقع على عاتق المعلمين والمدرسين فإن مستوى إعدادهم وتأهيلهم يعد عاملا مؤثرا في المستوى الذي سيكون عليه تلامذتهم وطلبتهم ، ولأن الإعداد لم يعد رصينا فإننا بتنا نرى انصراف بعض التلاميذ والطلبة عن الدراسة ، أما المستمرون فيها فإن نسبة لايستهان بها منهم تكون أقرب إلى الأميين منها إلى المتعلمين .
5- السياسة التعليمية والمناهج الدراسية :
ماهي فلسفة التعليم في العراق ؟ وما الذي نريده من التعليم ؟ وما الذي نريد أن نعلمه لأبنائنا ؟ وما هي خططنا للإرتقاء بمستوى التعليم في العراق ؟ اسئلة وغيرها كثير بحاجة إلى إجابات واضحة ومقنعة ، إذ ان عدم وضوح معالم هذه السياسة للعاملين في مجال التعليم ، أو عدم وجودها يعني ان التعليم يسير على وفق الإجتهادات والرؤى الخاصة وهي حالة تقود إلى تراجع التعليم بمراحله كافة ، وتزيد من حجم الفجوة بيننا وبين الأخرين .
أما عن المناهج فإن علينا معرفة الإجابة عن اسئلة اخرى ، ما الذي نريد إيصاله إلى التلاميذ والطلبة عن طريق المناهج الدراسية ؟ من هم الذين يقومون بوضعها ؟ ما الأسس المعتمدة في تحديث وتطوير وتغيير المناهج ؟ إن عدم وجود أو وضوح السياسة التعليمية ، وعدم رصانة المناهج الدراسية وجهلنا بالذي نريد تحقيقه عن طريقها ساهم بوجود أعداد كبيرة من خريجي المدارس لايجيدون القراءة والكتابة ، ويفتقرون إلى أبسط المعلومات عن الكثير من ميادين الحياة ، وليست لديهم الرغبة في تعليم أنفسهم ، ولايمتلكون القدرة على التفكير العلمي المنطقي .
الأثار السلبية للأمية :
1- الهدر في الموارد البشرية .
2- الهدر في الإقتصاد الوطني .
3- انتشار البطالة والفقر .
4- التأخر الثقافي والإجتماعي والعلمي لأفراد المجتمع .
5- محدودية ما يمكن الحصول عليه من خبرات ومعارف الأخرين بسبب عدم القدرة على القراءة .
6- بطء النمو الحضاري للمجتمع مما يؤدي إلى زيادة الفجوة مع المجتمعات الأخرى .
7- الإحجام عن المشاركة في الحياة السياسية .
8- عدم القدرة على المساهمة في إحداث التغيير المطلوب في مسيرة المجتمع وبنيته .
9- الجهل بالحقوق والواجبات .
10- ضعف التأثير في الأخرين .
انواع الأمية :
1- الأمية الثقافية : وتتمثل بالجهل بالكثير من المعلومات العامة وما يتعلق بماضي البلد وحاضره ، وما يجب معرفته عن الدول والمجتمعات الأخرى ، ومما يؤسف له ان هذا النوع من الأمية متفشي بين نسبة كبيرة من شبابنا .
2- الأمية السياسية : تفتقر نسبة لايستهان بها من شبابنا إلى المعرفة بأساسيات السياسة على الرغم من أن الشباب هم أداة مهمة من أدوات التغيير السياسي في العالم .
3- الأمية الإقتصادية : وهي أمية تحرم الفرد والمجتمع من تطوير وتنمية موارده بسبب الجهل بأسرار وخفايا وقوانين الإقتصاد ، إذ ان من الضروري للفرد أي كانت مهنته وتعليمه ان يفهم كيف يتحرك النشاط الإقتصادي وما هي مساراته ، وان يعرف بعض الإصطلاحات الإقتصادية ، فضلا عن معرفته بحقوقه الإقتصادية .
4- الأمية الدينية : وتتمثل في عدم معرفة صحيح الدين وأحكامه مما يؤدي إلى الإنحلال وظهور الأفكار المنحرفة ، او الإنجرار وراء التفسير الخاطىء والمتشدد للدين مما يقود إلى التطرف والإرهاب وكلاهما يسيء في النهاية إلى الدين ويَحرِف المجتمع عن المسار الصحيح للدين .
5- الأمية الإجتماعية : وهي الإفتقار إلى المهارات التي يتطلبها التواصل الإجتماعي كمهارات الحوار وحسن الإستماع ، والشجاعة الأدبية ، والقدرة على التفاعل مع الأخر وقبوله ، واحترام أراء الأخرين ، والثقة بالنفس . إن نقص هذه المهارات أو الجهل بها يسهم في ضعف المجتمع وفقدان الإنسجام بين أفراده .
6- الأمية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية : إنه لأمر غاية في الأهمية معرفة الفرد لحقوقه كي يطالب بها ويَحول دون سلبها منه ، وان الحقوق تكتسب منذ الولادة وليست منة أو هبة من أحد ، وان الديمقراطية ليست شعارات وإنما هي ممارسة لها أسسها واركانها التي يَحول الوعي بها دون إفراغ الأخرين لها من محتواها .
7- الأمية الصحية : وهي الجهل بالعادات الصحية السليمة مما يؤدي إلى اعتلال صحة أفراد المجتمع وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على جميع مجالات الحياة .
8- الأمية القانونية : على الرغم من أهمية القوانين للجميع لإرتباطها بكل مجالات الحياة إلا ان هنالك جهل لقطاعات واسعة من أفراد المجتمع بها ، ومن ذلك الجهل بانواعها وعواقب مخالفتها وتبعاتها والحقوق التي تضمنها للفرد ، وانواع المحاكم ، وانواع القضايا التي ترفع أمامها .
9- الأمية التقنية : وتتمثل بعد معرفة استخدام التقنيات الحديثة وكيفية استثمار إيجابياتها .
10- الأمية الأبجدية : وهي الجهل بالقراءة والكتابة وهو ما يقطع تواصل الإنسان مع محيطه الداخلي والخارجي ، ويفقده القدرة على التفاعل معه والتأثير فيه أو التأثر به .
وسائل مكافحة الأمية :
1- تطبيق قانون التعليم الإلزامي بدقة وصرامة من قبل الحكومة ولاسيما وزارة التربية ووضع الأُسَر أمام مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية والقانونية .
2- التوسع في فتح مراكز محو الأمية .
3- تأمين فرص العمل لتمكين أرباب الأسر من توفير مستلزمات معيشة أسرهم مما يجعلهم في غنى عن إجبار ابنائهم على العمل .
4- نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع عن طريق وسائل الإعلام المختلفة .
5- توفير الأبنية المدرسية اللائقة وتزويدها بكل ما يكفل اقتراب التلاميذ والطلبة منها وحبهم لها وتمتعهم بالأوقات التي يقضونها فيها .
6- حسن اختيار الطلبة المتقدمين لكليات التربية وأن تكون الرغبة في مهنة التدريس من بين أهم عوامل الإختيار .
7- رقابة الحكومة على سوق العمل لضمان عدم تشغيل الصغار خارج أو خلال اوقات المدرسة .
8- إعادة النظر بمناهج التعليم والإنتقال بها من القوالب الجامدة التي يجب حفظها إلى المعلومات التي تدفع التلاميذ والطلبة للتفاعل معها والتفكير بها ، وان يكون التلاميذ والطلبة محور العملية التعليمية بدلا من المعلم أو المدرس ، وأن يكون الأساس الفهم لا الحفظ .
9- متابعة السيرة الدراسية للتلاميذ والطلبة عن طريق التواصل بين إدارات المدارس وأولياء الأمور.
10- تفعيل دور مجالس الأباء والمعلمين والإبتعاد بها عن الشكلية وتطبيق ما جاء بنظامها .
11- حسن اختيار إدارات المدارس وتفعيل دور الإشراف التربوي .
12- إقامة دورات توعية لتأهيل المعلمين والمدرسين أثناء الخدمة للإرتقاء نوعيا بأدائهم .
13- تشجيع المواطنين على القراءة ودعم الدولة لأسعار الكتب .
14- تفعيل دور المكتبات المدرسية وتشجيع التلاميذ والطلبة على ارتيادها .
15- إعادة الحياة إلى المجلات المدرسية والنشرات الجدارية والإهتمام بها وتشجيع التلاميذ والطلبة على الكتابة فيها وتكريم المتميزين .
16- توجيه الإعلام بكل أنواعه على إقامة الندوات والحوارات وكتابة المواضيع الثقافية التي تتناول الجوانب التأريخية والقانونية والطبية والإجتماعية وما سواها للمساهمة في زيادة وعي الناس وتطوير ثقافتهم .
17- تشجيع التأليف والترجمة وان تتحمل الحكومة جزءا من تكاليف طباعتها .
18- ان تعيد القنوات التلفزيونية العراقية الحياة إلى البرامج العلمية والثقافية والأدبية والرياضية والتأريخية والقانونية والفنية التي كانت تظهر على شاشة تلفزيون العراق في ستينات وسبعينات القرن الماضي والتي ما زال العراقيون يذكرون اسهاماتها في إغنائهم بالمعلومات والإرتقاء بثقافتهم على أن يُحسَن اختيار مقدميها .
الشباب والإنحراف : الإنحراف في اللغة : هو الخروج عن الخط والميلان عنه ، والإنحراف شطط وشذوذ وتطرف ، ويعرف بأنه ( انتهاك لقواعد ومعايير المجتمع ) ، لذلك فإن الإنحراف يشكل خطرا كبيرا على المجتمع في حاضره ومستقبله إذا لم يتم التصدي له بحزم ، وإذا ما علمنا ان الشباب الذين هم بناة المستقبل اكثر عرضة للإنحراف من غيرهم لأسباب سنأتي على ذكرها لاحقا فإننا نكون أمام حقيقة مرعبة مفادها ان مجتمعنا يسير بإتجاه الإنحلال والضياع والإنسلاخ التام عن قيمه الدينية والإجتماعية التي شكلت وعلى مدى عقود حصنا لأفراده ودرعا واقيا من أخطار الإنحراف وأثاره .
اسباب الإنحراف :
1- ضعف الدور التربوي والرقابي للإسرة : ويعود ذلك لإنشغال الأبوين عن ابنائهم لأسباب عديدة منها الظروف الإقتصادية والمشكلات الأسرية والإهتمامات الشخصية لأحد الأبوين أو كلاهما مما يرفع الضغط عن الأبناء ويجعلهم يتصرفون كيفما شاؤوا .
2- ضعف الدور التربوي للمدرسة : إذ بات الدور الرئيس للمدرسة هو التعليم فقط بعيدا عن التربية ، وبذلك فقد المجتمع واحدة من أهم جهات التربية والتوجيه والتقويم .
3- ضعف الوازع الديني : تزرع الثقافة الدينية في النفوس التقوى والإلتزام وان إشاعتها بين الناس يجعلها حائلا بينهم وبين الإنحراف ، وعندما تغيب هذه الثقافة أو تتزعزع في النفوس يصبح الإنحراف امرا غير مستغرب .
4- ضعف رقابة مؤسسات الدولة : تعد الدولة بمثابة ولي أمر لجميع مواطنيها وعندما لايتحمل ولي الأمر مسؤولياته تلحق بالمجتمع أضرار كبيرة لعل من أهمها انسلاخ الشباب عن مجتمعهم والإنحراف عن القيم والأعراف والتقاليد التي تحكمه .
5- وسائل الإتصال الحديثة : وفرت وسائل الإتصال الحديثة فرصة أن يأتي العالم اليك بدلا من أن تذهب إليه وتُقَدِم كل ما يريد الفرد معرفته ، وهي بذلك سلاح ذو حدين يقدم الغث والسمين ، ومن المؤسف ان قطاعات لايستهان بها من الشباب تتجه إلى الغث والضار مما يسهم في انحرافه .
6- الفراغ والبطالة : يشترك الفراغ والبطالة بوجود وقت لايستثمر بشكل إيجابي وبسبب عدم وجود منافذ يعود إرتيادها بالنفع والفائدة على الشباب والعاطلين عن العمل فإن الإتجاه نحو أماكن اللهو غير البريء وممارسة الضار والسيء من العادات والممارسات يكون هو الإتجاه الغالب .
7- الفقر والثراء : قد يبدو أمرا متناقضا ان يدفع الفقر والثراء البعض من الشباب نحو الإنحراف إلا ان التناقض يختفي عندما نعلم ان الفقر قد يدفع الإنسان إلى اليأس ويصبح الإنحراف هروبا من واقع مرير يعيشه ، وقد يدفع الثراء في ظل غياب الرقابة إلى الإنحراف لأن الأموال تيسر ذلك الطريق لأصحابها .
8- اساءة فهم الحرية : بسبب نقص الوعي بمفاهيم الحرية واسسها وضوابطها وحدودها يعتقد البعض ان بإمكانه ان يعمل ما يشاء وفق ما يشاء وأين ما يشاء ، وهذه إشكالية تعاني منها العديد من المجتمعات في دول العالم الثالث ، وغالبا ما يقود هذا الفهم الشباب إلى الإنحراف .
9- التمرد على المجتمع : التمرد حالة تعاني منها العديد من مجتمعات العالم ولاسيما من فئة الشباب وإن تفاوتت نسب المتمردين وأعدادهم ، والتمرد غالبا ما يقود إلى الإنحراف عن تقاليد المجتمع وأعرافه وقيمه ومحاولة فرض سلوكيات غريبة عنه لتكون بديلا لما اعتاد عليه .
10- أصدقاء السوء : معروف للجميع مدى وحجم تأثير الأصدقاء على بعضهم البعض .
مظاهر الإنحراف :
1- تعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات وممارسة القمار بشتى أنواعه .
2- الإنحراف الجنسي .
3- التقليد الأعمى للسلوكيات والثقافات الغريبة عن مجتمعنا .
4- الإبتعاد عن الحشمة والوقار في الملبس والتصرفات .
5- عدم الإلتزام بتعاليم الدين وقيم المجتمع وعاداته وتقاليده .
6- إساءة استخدام الحرية الشخصية .
7- ارتياد أماكن اللهو غير البريء .
8- إعتماد الوسائل المشروعة وغير المشروعة للحصول على المال لتغطية نفقات الكحول والمخدرات والقمار .
9- ضعف الإيمان .
10- متابعة المواقع الإباحية على شبكة الإنترنيت والقنوات الفضائية والترويج لها .
11- الإستعانة بوسائل الإتصال الحديثة لبث الأفكار المنحرفة ونشرها بين الشباب .
12- التصرفات الفوضوية وغير المسؤولة ، وعدم تقبل النصح والإرشاد .
الأثار السلبية للإنحراف :
1- الإبتعاد عن تعاليم الدين وقيمه .
2- انسلاخ الشباب عن مجتمعهم وقيمه وعاداته وتقاليده وتردي الأخلاق .
3- توجيه طاقات الشباب إلى مجالات تسهم في هدم المجتمع وتأخره .
4- الهدر الإقتصادي بسبب توجه الشباب نحو مجالات تلحق الضرر بإقتصاد البلد .
5- تَحَول الشباب من عنصر منتج إلى عنصر مستهلك .
6- هدر أوقات الفراغ في ممارسات تسيء إلى الشباب وتضر بصحته وتستنفد طاقاته في غير موضعها وما يفترض أن تسخر له .
7- الإستثمار السيء لوسائل الإتصال الحديثة وهي التي يمكن الإفادة منها في بناء البلد وتطويره .
8- إنحلال الأسرة وتشتتها وهي التي تعد ركيزة المجتمع .
9- إساءة إستخدام الحرية بما يحيلها إلى فوضى لاضابط لها .
10- تفشي مظاهر الفساد بكل أشكاله .
11- رواج الثقافات المستوردة وشيوعها على حساب ثقافة المجتمع وهويته وأصالته .
وسائل مكافحة الإنحراف والوقاية منه :
1- ممارسة الأسرة والمدرسة ومؤسسات الدولة وفئات المجتمع لدورها التربوي والرقابي إذ ان مسؤولية تقويم الشباب وغرس تعاليم الدين وقيم وتقاليد وأعراف المجتمع في نفوسهم تقع على عاتق تلك الجهات مجتمعة ، وهي مسؤولية تستمد جسامتها وخطورتها من جسامة وخطورة الدور الذي سيناط مستقبلا بالشباب لكونهم قادة الغد وبناة المستقبل .
2- الرقابة الفاعلة لأجهزة الدولة على أماكن اللهو ومنع بيع وتداول الأفلام والمجلات الإباحية وتغليظ العقوبة على المتاجرين بها وبائعيها .
3- مكافحة المخدرات التي أصبح العراق مليئا بها بعد ان كان خاليا منها ، ومراقبة الحدود لضمان عدم دخولها وتغليظ العقوبة على المتاجرين بها ومتعاطيها .
4- إيجاد فرص عمل للشباب في مختلف قطاعات العمل .
5- تفعيل دور وسائل الإعلام في نشر الوعي الديني والقيمي وشرح مضار الإنحراف وخطورته .
6- العمل من خلال الأسرة والمدرسة والمعهد والكلية على بناء شخصية الشباب بناءا متوازنا رصينا يجعلهم بمأمن من المظاهر السيئة للثقافات الغربية .
7- الإكثار من الأماكن التي يستثمر فيها الشباب اوقات فراغهم إيجابيا كالأندية الرياضية والملاعب الشعبية ، وتفعيل دور مراكز الشباب والإرتقاء بإمكاناتها لما تقدمه من تنوع في إختصاصاتها يمكن عن طريقه إستقطاب قطاعات واسعة من الشباب .
8- مساهمة الحكومة في تشجيع الشباب على الزواج عن طريق سلف الزواج وبناء المجمعات السكنية لإشغالها من قبل المتزوجين الشباب بشروط ميسرة وأسعار مدعومة .
9- التذكير برموزنا الإسلامية وسيرتهم الحميدة ، ورموزنا الوطنية والإجتماعية التي يزخر بها تأريخنا ، وبرموز حاضرنا ليتخذهم الشباب قدوة لهم بدلا من الشخصيات الأجنبية التي لاتمت لنا بصلة بعد أن ضاع دور القدوة ومفهومه وتلاشت أهميته أو تكاد .
10- التثقيف بمعنى الحرية ومفهومها ورسم حدودها ومدياتها ، وماهية الحرية الفردية وعلاقتها بالحرية العامة .
11- التثقيف بأهمية المواطنة ودورها وان من أبرز صور التعبير عنها الإجتهاد في معرفة كل مفيد وتسخيره لخدمة الوطن والمجتمع ، ومكافحة كل ما يسيء إليه ويعرقل تقدمه .
12- أن يكون لوزارة الشباب والرياضة دور واضح المعالم في بناء الشباب واستثمار طاقاتهم وإبداعاتهم ، ورعاية الموهوبين منهم في شتى المجالات ، فضلا عن إستثمار أوقات فراغهم إيجابيا .